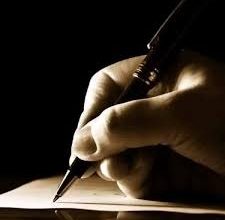“هل تنفجر الأوضاع؟ هل قبلت الدول العربية خطة الرئيس ترمب دون أى شروط ؟؟” بقلم.. محمد الحسن محمد نور

في مشهد يستحضر أجواء الحرب الباردة، جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كبار قادة الجيش من مختلف أنحاء العالم داخل قاعدة عسكرية بولاية فرجينيا، في اجتماع وُصف بالمفاجئ والغامض. جاء هذا التجمع في توقيت حساس تتزايد فيه التوترات مع روسيا والصين، وسط حديث عن مضاعفة الإنتاج العسكري الأمريكي، واستعداد واشنطن لفرض نفسها مجدداً في آسيا الوسطى .
في الوقت نفسه، يتصاعد التوتر بين واشنطن وإسرائيل من جهة، وطهران من الجهة الأخرى. فبينما تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري بطائرات التزود بالوقود، تتواتر الأنباء عن استلام إيران لأنظمة دفاع جوي ومقاتلات متطورة من روسيا، مهددةً برد قاسٍ إذا تعرضت لأي هجوم. عاد البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة وسط حديث عن صواريخ بعيدة المدى مع تراجع فرص الدبلوماسية. المنطقة تقف على شفا مواجهة قد تغير قواعد اللعبة بالكامل. فهل نحن أمام تمهيد لحرب كبرى، أم أن ما يجرى مجرد رسائل ردع في لعبة النفوذ الدائرة حالياً؟
المؤتمر الذي عقد في البيت الأبيض برعاية ترمب كان في حقيقته محاولة قوية لإسكات جبهة غزة بصورة مؤقتة، ضمن خطة هجومية دفاعية أوسع تُدار بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بمساندة أوروبية، بهدف تثبيت نفوذ واشنطن المتراجع عالمياً وضرب التحالف الجديد الذي يزعزع هذا النفوذ.
حدثان رئيسيان كانا وراء تحرك الرئيس ترمب بقوة للخروج من المأزق. الأول: قيام إسرائيل بوضع اللمسة الأخيرة على المشهد المتوتر بخوض مغامرة متهورة بمحاولة اغتيال قيادات حماس على أراضي دولة قطر، المصنفة والمعرفة بالحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة خارج حلف الناتو. مثلت هذه الخطوة انتهاكاً صارخا للسيادة القطرية واعتبرت خطأ استراتيجياً فادحاً كاد أن يودي بالتحالفات الأمريكية مع الدول العربية، والتي تحمل أهمية كبرى للاستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
أما الحدث الثاني: فهو موجة الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، والتي انطلقت نتيجة للوضع الإنساني النازف في غزة، حيث أثارت الوحشية الإسرائيلية ومشاهد الدمار والاشلاء والتجويع غير الإنساني موجة غضب عالمية، دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى الدخول في موجة من الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين.
تحرك ترمب بقوة ودعا إلى مؤتمر يعقد في البيت الأبيض بحضور ثمانية من الدول العربية والإسلامية، بهدف استعادة الثقة للحلفاء الذين بدأوا في الابتعاد عن المحور الأمريكى، ثم دفعهم للقبول بما سُمي “خطة ترمب للسلام” المكونة من عشرين بنداً.
أما فيما يختص بتحقيق إعادة الثقة وإنقاذ التحالف العربي-الأمريكي من التفكك، فقد قام الرئيس ترمب باجباررئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “علنا” على الاعتذار لقطر كخطوة أولى، ثم أتبعها بتوقيع “اتفاقية دفاع مشترك” مع قطر تضمنت بنداً ينص على اعتبار أي اعتداء على قطر هجوماً يستدعي الرد الأمريكى. “حتى لو كان الهجوم من قبل إسرائيل ؟”
أما جوهر الخطة العشرينية، فهو يصب في مصلحة إسرائيل بالكامل ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. أما فى تفاصيلها، فإن الخطة تهدف أولاً إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية، وتبادل المعتقلين، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي “المتدرج” من قطاع غزة، ثم إعادة الإعمار. إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً لأنها جاءت مصحوبة بتهديد واشتراط قبولها من قبل حماس خلال 48 ساعة، في حين أن انسحاب إسرائيل من القطاع ترك دون جدول زمني محدد.
تمثل الخطة آلية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات العاجلة (600 شاحنة يومياً)، ومنع التهجير القسري. وقد رحبت الدول الثماني بهذه المخرجات كخطوة أولى ضرورية لوقف المعاناة، رغم ما أثارته باكستان من “لغط” حين أعلنت أن الخطة التي وافقوا عليها تختلف عن التي أُعلنت، وأن النسخة المعلنة قد تم تعديلها بعد التوقيع عليها بواسطة اسرائيل.
الترحيب بالخطة أو قبولها بدون شروط من شأنه أن يسفر إخراج إسرائيل وأمريكا من العزلة الدبلوماسية، ويضع حركة حماس في زاوية سياسية خانقة أمام مشهد عربي رسمي خامد، لا قدرة له على تحويل هذه الموافقة الشكلية إلى حماية فعلية للقضية الفلسطينية، مما يمهد لتصفية مباشرة للقضية.
إسكات جبهة غزة مؤقتاً يتيح الفرصة لأمريكا للانطلاق إلى واجهة ثانية: إيران. هذه الجبهة تقترب من نقطة الانفجار مع اقتراب أجل الاتفاق النووي في الثامن عشر من أكتوبر. فالولايات المتحدة تعزز وجودها الجوي واللوجستي (بطائرات التزود، وخطط الطوارئ المشتركة، والاستعدادات الاستخباراتية) كتمهيد لسيناريو عسكري محتمل. يبقى السؤال: هل الهدف ضبط سلوك طهران عبر الضغوط، أم فتح جبهة تبريرية لصراع أوسع؟ وهل يكفي إسكات الجبهة العربية لتمرير ضربة قد تشعل انتشاراً إقليمياً؟
بالتزامن مع ذلك، تشعل واشنطن محور الكاريبي، ربما كبالون اختبار لقياس رد فعل الصين وروسيا. بدأ التصعيد باستفزاز فنزويلا ورفع المكافأة على رأس الرئيس نيكولاس مادورو إلى خمسين مليون دولار، ثم أعقب ذلك تحركات بحرية مكثفة (بارجات ومدمرات وغواصات) باتجاه سواحل فنزويلا، مع تمرير وحدات بحرية عبر قناة بنما. حاولت واشنطن تبرير هذه التحركات بمهام مكافحة المخدرات والأمن البحري. رداً على ذلك، صعد مادورو من خطابه الشعبي والميليشياوي، مهدداً بردود واسعة وإعلان حالة طوارئ دفاعية إذا ما تصاعدت التحركات إلى عدوان. هذا المحور يبرز احتمالين: الأول أن واشنطن تسعى لإحكام نفوذها في نصف الكرة الغربي وقطع الطريق أمام انزلاق دول أمريكا اللاتينية نحو محاور بديلة، والثاني أن لعبة التهديد بقناة بنما قد تضخم المخاطر بدلاً من احتوائها.
وتمضي واشنطن في حملتها التصعيدية، التي يفسرها المراقبون بأنها استماتة في الدفاع عن طريق الهجوم. ففي شرق المتوسط وأوروبا، وبعد أن فشل ترمب في إنهاء الحرب الأوكرانية-الروسية كما وعد، تتصاعد المواجهة مع روسيا بحدة. أظهرت واشنطن تحريكاً لمنصات بحرية واستعراضات قوة (بنشر غواصات وتحركات بحرية)، ولم تكتف موسكو بالرد بالتصريحات بل بلغت حد السخرية العلنية من بعض الأوصاف الأمريكية، ما يعكس تصعيداً كلامياً قد يقود إلى منعطفات أكثر خطورة. هذه المسارات تُظهر أن المواجهة الأمريكية-الروسية لم تعد تدور في فلك المفاوضات بل دخلت مرحلة الخطورة.
في سياق مواز، دخلت إسرائيل حلبة أوسع بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي من نوع “باتريوت” (وحدات كانت إسرائيل تشغلها سابقاً)، مما يشير إلى أن الاصطفاف الأمريكي-الإسرائيلي يمتد الآن إلى ساحات المواجهة مع روسيا في أوروبا الشرقية، ويجعل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب أكثر شمولاً من كونهما قضية إقليمية فقط. هذا الدعم المتقاطع يعيد تشكيل موازين القوى ويحول إسرائيل إلى لاعب وظيفي في جبهات متعددة.
ربط هذه الجبهات – من فلسطين مروراً بإيران وروسيا، وصولاً إلى الكاريبي – يقودنا إلى عنصر محوري لم تُخفِه الاستراتيجية الأمريكية: البعد الصيني. بينما تنحصر قدرة واشنطن على الانتشار الفعلي في أساطيل متفرقة وعدد من القواعد، تواصل بكين توسيع هيمنتها على الممرات البحرية وطرق الإمداد عبر أسطول متزايد وحضور استثماري في موانئ العالم. هنا يظهر العامل الذي تخشاه واشنطن: مواجهة عسكرية وسياسية متنقلة من جانب أمريكا مقابل بناء دائم للقدرات البحرية واللوجستية من جانب الصين؛ مما يجعل أي مواجهة إقليمية – إذا ما انتقلت إلى طور أوسع – مسألة ذات انعكاسات خطيرة على خطوط الإمداد الدولية والاقتصاد العالمي.
يبدو البيت الأبيض اليوم أقل اهتماماً بـ “حل القضية” الفلسطينية، وأشد حرصاً على تأمين البيئات الاستراتيجية لخطوات قاسية قد تُتخذ ضد طهران أو تُستثمر لردع موسكو، بينما تبقى تداعيات ذلك على منطقة الشرق الأوسط والبشرية مضاربة مفتوحة.
الخلاصة: ما بدا مؤتمراً صحفياً موحداً هو في الواقع بداية مسار منظّم لإعادة هندسة الساحات، من القدس إلى الخليج، ومن البحر الأسود إلى البحر الكاريبي، ثم إلى المحيطات. لا يمكن قراءة هذا التفعيل على أنه إدارة أزمات بعقلية احتواء فقط؛ إنه إعادة ترتيب جيوستراتيجي تفضي إلى سؤال مرعب: هل ندفع نحو صدامات متزامنة أم نحو سلسلة تصعيد تُدار بمنطق التراكم؟
وفى تقديرنا أنه لا يكفي أن تعلن الدول الثمانية تحفظاتها؛ الأهم هو أن تشترط شرطاً محورياً يقلب المعادلة: بأن تنفرد بتشكيل وإدارة الهيئة الانتقالية في غزة، ضماناً لكفاءة وحياد العملية وتمهيداً حقيقياً لإعادة توحيد الأرض الفلسطينية. ولسحب ذريعة “الإقصاء” من واشنطن وتل أبيب، يمكن منحهما “حق التشاور” في الشؤون الإنسانية والأمنية المباشرة التي تخصهما، على أن يظل هذا الحق استشارياً محصوراً في إطاره، وغير مسوغ للتدخل أو النقض. بهذا فقط يتحول الترحيب بهذه الخطة من انكسار تكتيكي إلى مناورة استراتيجية تحافظ على الباب مفتوحاً أمام حل الدولتين، وتقطع الطريق على تحول أي هياكل انتقالية إلى غطاء لهيمنة أمنية دائمة، في مواجهة مشروع إقليمي يعيد هندسة الجغرافيا بمفاهيم القوة وحدها.
محمد الحسن محمد نور
الثالث من أكتوبر ٢٠٢٥